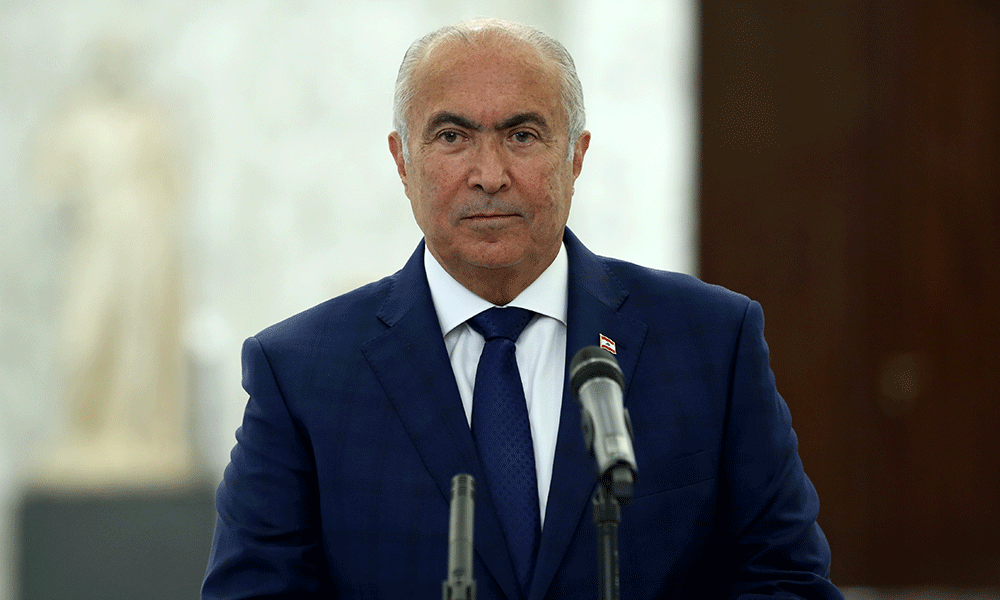ما بَعدَ الجماعة في لبنان: الدَولَةُ بوَصفِها آخر خياراتِ النجاة

البروفِسور بيار الخوري*
في لحظةٍ فارِقةٍ تاريخية في لبنان، تبدو الدولةُ كيانًا مُستَهدَفًا في المُعادلة الداخلية، لكنها في الوقت نفسه لا تزالُ تَحتِكِرُ شرعيةَ التمثيلِ الدولي، وإطارَ الاعترافِ الدولي، وحَيَوِيَّةَ الكيانِ اللبناني كما هو مفهومٌ في النظامِ الدولي.
يَكشُفُ هذا التناقُضُ عن أزمةٍ هيكلية لا تُؤثّرُ فقط في مؤسّسات الدولة، ولكن أيضًا في الهيكل الطائفي نفسه، وفي العقلِ الجمعي للجماعات اللبنانية التي تعاملت منذ فترةٍ طويلة مع الدولة ليسَ ككيانٍ سيادي فوق الانتماءات، ولكن كأداةِ توازُنٍ داخل لعبة المجموعات ذاتها.
تاريخيًا، لم تَكُن الدولةُ اللبنانية مَبنيَّةً على أُسُسِ الدولةِ الحديثة التي تحدّثَ عنها فلاسفة العقود الاجتماعية مثل الإنكليزي توماس هوبز أو الفرنسي جان جاك روسو، بل كانت نتاجَ توازُن المصالح بين الطوائف، بدلًا من الإرادة الشعبية المُوحّدة. كانت الدولةُ مُجرّدَ مظروفٍ هَشّ، تناوبت الطوائف على السيطرة على الحصص والتفاوُض عليها، بدون أن تؤمِنَ فعليًا بمبدَإِ احتكارِ القرار الوطني أو السيادة القانونية. في مرحلةٍ ما من تاريخها، رفضت كلُّ جماعةٍ لبنانية أن تكون الدولة سلطة أعلى إذا شعرت أنها لا تُجَسّدُ مصالحها أو تحميها.
فعندما رَؤوا الكيانَ مُهَدَّدًا، دعم الموارنة فكرة وجود ميليشيا خاصة وراهنوا على الغرب؛ عندما شعرَ السُنَّة بالتهميش، استبدلوا الدولة بالهوية العروبية؛ وكان الدروز يعاملون الدولة دائمًا على أنها حليفٌ غير موثوقٍ به في ظلِّ موازين قوى مُتغيِّرة. وبعد استتباعٍ طويل لهوياتٍ سياسيةٍ إقليميةٍ واُمَميّة، ثبّت الشيعة سلاحهم المدعوم من الثورة الإيرانية كمصدرٍ للسلطة والمكانة.
لكن ما يَتَغَيّرُ اليوم ليس فقط موقع المجموعات داخل المُعادلة، ولكن طبيعة هذه المجموعات نفسها. إنَّ الهياكلَ الطائفية التقليدية تتآكلُ من الداخل: فَقَدَ الخطابُ النمطي جاذبيته، ولم تَعُد السلطاتُ الدينية قادرةً على السيطرة على الخطاب العام، وانهارَ الاقتصادُ الرَيعي الطائفي، ولم تَعُد الخدمات التي كانت تُقَدَّمُ نيابةً عن المجموعة مُتاحة. وباعتباره ملاذًا ومجتمعًا صغيرًا، يفقدُ الإطارُ الطائفي وظيفته الأساسية، حيث يتراجع من كونه هويَّةً حيّة إلى إطارٍ رسمي يُستَخدَمُ عندما ينمو الخوف ويتلاشى مع كلِّ أملٍ مُتَجَدِّد. مع هذا التغيّر، تُواجه الجماعات في لبنان أزمةً مزدوجة: فهي لا تَثِقُ بالدولة ولا ترى فيها خلاصها، لكنها لم تَعُد تمتلك نفسها كمجموعة مستقلة يُمكنها إدارةَ حياتها أو الدفاع عن نفسها.
وفي هذا السياق، تظهرُ الدولةُ الضعيفة كمُفارقة مركزيّة. هي غيرُ قادرةٍ على فَرضِ سيادتها ومشروعها بقوّة القانون، ولكنها تظلُّ الكيانَ الوحيد الذي يمنح الطوائف وجودًا في النظام الدولي. هي شرطُ المساعدات، والاعتراف بالحدود، والتعامل مع صندوق النقد الدولي، والاتفاقات المُوَقَّعة. الدولةُ هنا لا تُحتَرَمُ كقوّة، ولكنها لا تزالُ ضرورة. إنه رمزٌ يكتنفه الكثير من عدم المعنى، لكنه أمرٌ لا غنى عنه.
يعكسُ هذا الوضع ما وصفه الفيلسوف الإيطالي أنطونيو غرامشي بأنه أزمةُ هَيمَنة: فَقَدَت النُخَبُ قيادتَها الأخلاقية والفكرية، وفَقَدَت الطوائف قُدرتَها على إنتاجِ المعنى، وفَقَدَت الدولة قُدرتَها على احتكارِ السلطة. نحنُ في لحظةٍ قبل التغيير أو الانهيار، حيثُ لا تزالُ الكيانات القديمة موجودة، لكن روحها قد ذبلت. لا تزال الدولة موجودة، لكن وظيفتها قد انحصرت بكونها ضرورة للاستمرارية، ممنوعة من التقدُّم كمشروعٍ جماعي للبناء أو الخلاص.
وهكذا، تصبح الدولة، في أكثر لحظاتها ضعفًا، أقوى العناصر المُتَبَقّية من التماسُك، ليس لأنها تُمثّلُ شخصًا حقيقيًا، ولكن لأنها لا تزال تُمثّلُ الكُلّ. في لحظةِ انهيارِ القوة الذاتية للجماعات، لا تُصبِحُ الدولة فوقها، ولكنها تُصبحُ الاكثر شأنًا، لانها تظلُّ الوحيدة التي يمكن للمجموعات التمسُّك بها عندما يَسقُطُ وينهارُ كلُّ شيء.